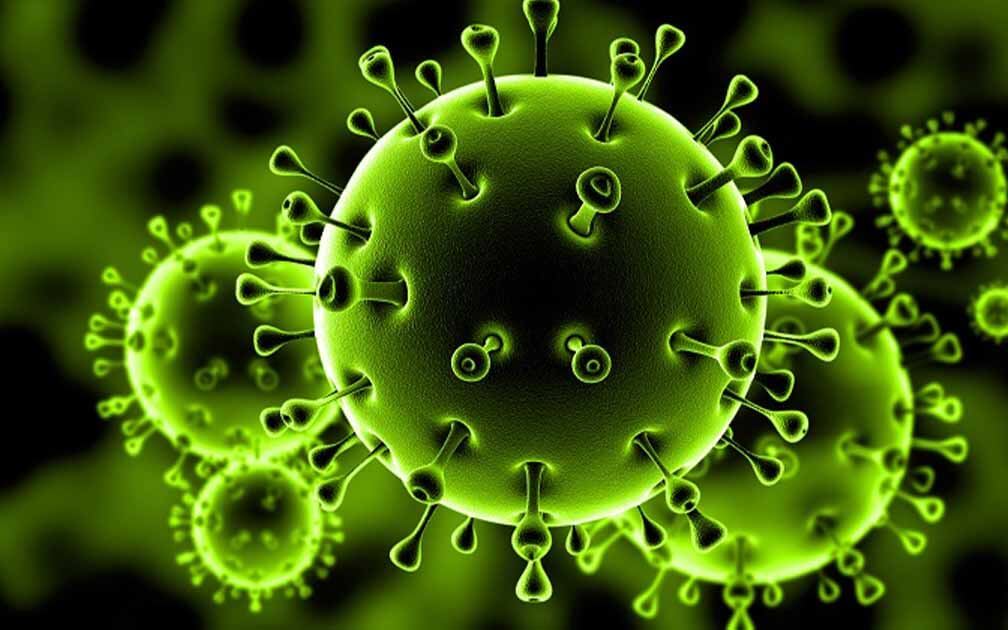كينيث روجوف*
كمبريدج ــ مع مرور كل يوم، تبدو الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008 على نحو متزايد وكأنها كانت مجرد عينة تجريبية للكارثة الاقتصادية التي تنتظرنا اليوم. الواقع أن انهيار الناتج العالمي في الأمد القريب، والذي بدأ بالفعل، من المرجح أن ينافس أو يتجاوز أي ركود في السنوات المائة والخمسين الأخيرة.
حتى على الرغم من الجهود الشاملة التي بذلتها البنوك المركزية والسلطات المالية لتخفيف الضربة، انهارت أسواق الأصول في الاقتصادات المتقدمة، وكان رأس المال يتدفق إلى خارج الأسواق الناشئة بوتيرة مذهلة. والآن لم يعد من الممكن تجنب الركود الاقتصادي العميق والأزمة المالية. السؤال الرئيسي الآن هو إلى أي مدى قد يكون الركود سيئا وإلى متى قد يستمر.
إلى أن نعرف مدى سرعة وشمول الاستجابة لتحدي الصحة العامة، يكاد يكون من المستحيل عمليا أن يتنبأ أهل الاقتصاد بنهاية هذه الأزمة. على الأقل، بقدر جسامة عدم اليقين العلمي بشأن فيروس كورونا، سيكون حجم عدم اليقين الاقتصادي الاجتماعي حول كيفية تصرف عامة الناس وصناع السياسيات في الأسابيع والأشهر المقبلة.
إن العالَم يشهد شيئا أشبه بغزو من الفضاء. نحن نعلم أن الـغَـلَـبة ستكون للعزيمة البشرية والإبداع الإنساني. ولكن بأي ثمن؟ حتى كتابة هذه السطور، تبدو الأسواق متشبثة بأهداب الأمل الـحَـذِر في أن يأتي التعافي سريعا، والذي ربما يبدأ في الربع الرابع من هذا العام. ويشير العديد من المعلقين إلى تجربة الصين باعتبارها بشيرا مشجعا بما ينتظر بقية العالم.
ولكن هل لهذا المنظور ما يبرره حقا؟ لقد انتعش تشغيل العمالة في الصين بعض الشيء، ولكن ليس من الواضح على الإطلاق متى قد يعود إلى أي مستوى قريب من مستويات ما قبل الجائحة. وحتى إذا انتعش التصنيع الصيني بالكامل، فمن سيشتري هذه السلع عندما يكون الاقتصاد العالمي في انهيار؟ أما عن الولايات المتحدة، فإن العودة إلى 70 % أو 80 % من طاقتها يبدو حلما بعيد المنال.
الآن، بعد أن فشلت الولايات المتحدة على نحو مروع في احتواء تفشي المرض على الرغم من امتلاكها النظام الصحي الأكثر تقدما في العالم، سوف يواجه الأميركيون صعوبة بالغة في العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية إلى أن يصبح اللقاح متاحا على نطاق واسع، وهو ما قد يستغرق عاما أو أكثر. وهناك حتى العديد من الشكوك بشأن الكيفية التي قد تجري بها الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
في الوقت الحالي، يبدو أن برامج التحفيز الأميركية الضخمة تساعد في تخفيف توتر الأسواق، والحق أن هذه البرامج كانت ضرورية قطعا لحماية العمال العاديين ومنع انهيار السوق. ومع ذلك، بات من الواضح بالفعل أن الأمر يستلزم بذل جهود أكبر من ذلك كثيرا.
إذا كان الأمر مجرد ذعر مالي من نوع أو آخر، فإن ضخ مبالغ ضخمة من قِبَل الحكومة لتحفيز الطلب كان ليكفي لحل الأزمة. لكن العالم يشهد أخطر جائحة منذ تفشي مرض الإنفلونزا في الفترة 1918-1920. وإذا مات 2 % من سكان العام هذه المرة، فإن حصيلة الموتى قد تصل إلى ما يقرب من 150 مليون إنسان.
ما يدعو إلى التفاؤل أن النتيجة لن تكون بهذا القدر من التطرف في الأرجح، وذلك نظرا لعمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصارمة التي يجري تبنيها على مستوى العالم. ولكن إلى أن يتم حل الأزمة الصحية، سيبدو الوضع الاقتصادي قاتما للغاية. وحتى بعد استئناف النشاط الاقتصادي، سوف يخلف الضرر الذي لحق بالشركات وأسواق الديون تأثيرات سلبية بعيدة الأمد، خاصة وأن الديون العالمية كانت بالفعل عند مستويات غير مسبوقة قبل بدء الأزمة.
من المؤكد أن الحكومات والبنوك المركزية تحركت لدعم مساحات واسعة من القطاع المالي على نحو يبدو صينيا تقريبا في شموله؛ كما أنها تملك القوة اللازمة للقيام بالمزيد إذا لزم الأمر. لكن المشكلة هي أن ما نشهده ليس مجرد صدمة على جانب الطلب بل نشهد أيضا صدمة هائلة على جانب العرض. وربما يساهم دعم الطلب في تسطيح منحنى العدوى من خلال مساعدة الناس في البقاء حبيسين، ولكن هناك حدود لمقدار مساعدة الاقتصاد بهذه الطريقة، إذا بقي 20 % إلى 30 % من قوة العمل في العزل الذاتي على مدار قسم كبير من العامين المقبلين.
لم أتطرق حتى إلى حالة عدم اليقين السياسي العميقة التي قد يثيرها الكساد العالمي. إذا ما علمنا أن أزمة 2008 المالية تسببت في إحداث شلل سياسي عميق وعملت على تغذية زمرة من القادة الشعبويين المناهضين للتكنوقراط، فيمكننا أن نتوقع أن تُـفضي أزمة مرض فيروس كورونا 2019 إلى ارتباكات أشد حدة. كانت استجابات الصحة العامة في الولايات المتحدة كارثية، بسبب تركيبة من انعدام الكفاءة والإهمال على العديد من مستويات الحكم، بما في ذلك أعلاها. وإذا استمرت الأحوال على ما هي عليه الآن، فقد تتجاوز حصيلة الموتى في مدينة نيويورك وحدها نظيرتها في إيطاليا بالكامل.
بطبيعة الحال، يستطيع المرء أن يتخيل سيناريوهات أكثر تفاؤلا. ففي ظل الاختبارات المكثفة، يمكننا تحديد من هم مرضى ومن هم أصحاء، ومن لديه المناعة بالفعل وهو بالتالي قادر على العودة إلى العمل. مثل هذه المعرفة لا تقدر بثمن. ولكن مرة أخرى، نظرا لطبقات عديدة من سوء الإدارة ورداءة ترتيب الأولويات والتي تمتد لسنوات عديدة سابقة، فإن الولايات المتحدة تفتقر على نحو مؤسف لقدرات الاختبار الكافية.
حتى في غياب اللقاح، من الممكن أن يعود الاقتصاد إلى حالته الطبيعية بسرعة نسبيا إذا جرى تنفيذ العلاجات الفعّالة بسرعة. ولكن في غياب الاختبارات واسعة النطاق وإدراك واضح لما قد يُـعَد “طبيعيا” في غضون عامين، فسوف يكون من الصعب إقناع الشركات بالعودة إلى الاستثمار والتوظيف، وخاصة عندا تتوقع فواتير ضريبية أعلى عندما تنتهي الأزمة. وربما كانت خسائر سوق الأسهم حتى الآن أقل من خسائرها في عام 2008 فقط لأن الجميع يتذكرون كيف عادت القيم إلى الارتفاع خلال التعافي. ولكن ما دام قد تبين لنا أن تلك الأزمة كانت مجرد عينة تجريبية من الأزمة الحالية، فلا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا حدوث انتعاش سريع.
سوف يتوصل العلماء إلى المزيد من المعلومات عن هذا الغازي المجهري في غضون بضعة أشهر. ومع اندفاع الفيروس الآن عبر الولايات المتحدة، سيتمكن الباحثون الأميركيون من الوصول المباشر إلى البيانات والمرضى، بدلا من الاضطرار إلى الاعتماد فقط على البيانات القادمة من إقليم خوبي الصيني. ولن يتسنى لنا تقييم تكلفة الكارثة الاقتصادية التي خلفها هذا الغزو في أعقابه إلا بعد صده وهزيمته.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
*كبير خبراء الاقتصاد الأسبق لدى صندوق النقد الدولي، وأستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد.
*حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2020.
www.project-syndicate.org